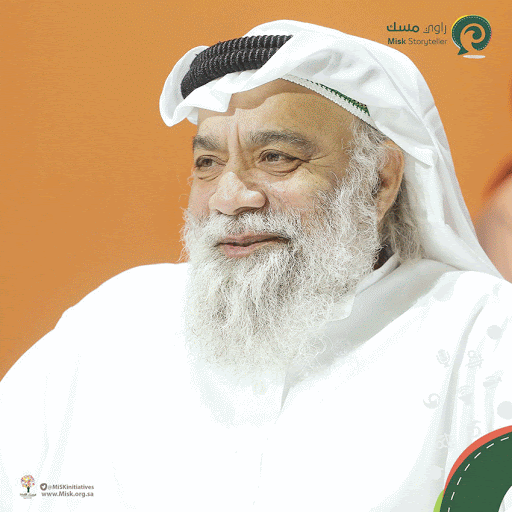نظم الشاعر الوطني الفلسطيني الكبير الراحل محمود درويش قصيدته “ريتا والبندقية” عام 1967 إبان وجوده على أرض وطنه المحتلة ضمن “أراضي 48“ والتي غادرها مطلع السبعينيات إلى موسكو فالقاهرة حاطاً الرحال في بيروت، لكن القصيدة اكتسبت شهرة مدوية من لبنان إلى جميع أرجاء العالم العربي بعد أن غناها ولحنها الموسيقار اللبناني الوطني الكبير مارسيل خليفة ؛ حيث أضحت بعدئذ رائعة من روائع أغانيه يرددها ملايين العرب ويطلبون منه تأديتها في حفلاته الموسيقية أينما حل ضيفاً على أي بلد عربي.
بيد أن الاعتقاد ظل سائداً لدى الغالبية العظمى من محبي فن خليفة وقصائد درويش بأن “ريتا” هي رمز لوطنه السليب فلسطين في حين لم تكن ريتا سوى إسم مستعار لحبيبته اليهودية “تمار بن عامي” التي لها والدان ينتميان إلى بلدين اشتراكيين سابقين، فالأب بولندي والوالدة روسية، ولعلهما هاجرا إلى فلسطين قبل نكبتها في 1948، وقد عاش معها شاعرنا قصة حُب فعلية عاصفة لم تستمر أكثر من عامين لموقفها السلبي من العدوان الأسرائيلي على العرب 1967، على أن شاعرنا ظل أسيراً بمشاعره الجارفة لذكريات تلك القصة الغرامية الأليمة النهاية والعصية على نسيانه إياها طوال إقامته المديدة خارج وطنه في الشتات حتى وفاته الفاجعة عام 2008 في هيوستن بالولايات المتحدة إثر عملية جراحية في القلب عن عمر ناهز ال 67 عاماً.
ولم تكن القصيدة أصلاً بتلك الشهرة التي أضحت عليها قبل أن يغنيها الفنان مارسيل خليفة؛ لا بل لم تكن الأعمال الشعرية وسائر الأعمال الأدبية لأدباء عرب 48 معروفة أصلاً عند النخبة المثقفة وجمهرة المثقفين والقراء العرب إلا غداة نكسة 1967، إذ ظلت أعمالهم مجهولة لديهم ما يقرب من عشرين عاماً منذ نكبة 48 ؛ وذلك بفعل طوق العزلة المضروب عليهم من قِبل سلطات الاحتلال ، فضلاً عن المقاطعة الكلية الشاملة المتبادلة بين العرب وإسرائيل.
وبعد تسليط بعض وسائل الإعلام العربية عليها؛ انبهر المثقفون العرب انبهاراً شديداً بتلك الأعمال الأدبية لقوة تعبيرها عن قضية نضال الشعب الفلسطيني وعن نضالات جزء من هذا الشعب ظل متمسكاً بأرضه ولم يفلح عدوه في اقتلاعه من جذوره؛ لا تشريداً ولا قتلاً، فأضحوا شوكةً في حلق عدوهم إلى يومنا؛ وأخذوا يكيلون المديح والتقريظ فيها ، حتى تصدى لهم شاعرنا الخجول ببيانه الشهير “أنقذونا من هذا الحُب القاسي”.
وكان الشهيد الفلسطيني الروائي الراحل غسان كنفاني المقيم في بيروت هو من أول من عرفوا عالمنا العربي بأدباء المقاومة داخل “إسرائيل”. ورغم كل الاعتقادات التي ترسخت بأن “ريتا” في القصيدة هي فلسطين معشوقة الشاعر دون أن يخطر ببالهم ولو في الخيال بأنها حكاية حُب تجمع درويش مع معشوقته الفعلية اليهودية تمار/ “ريتا”، فإن الشاعر لم يكشف النقاب عنها إلا قبل بضع سنوات من رحيله تلميحاً وبصورة ملتبسة خجولة تقترب من الوضوح بما فيه الكفاية للإعلامي اللبناني اللبيب عباس بيضون وإعلامي فرنسي آخر.
بدأت القصة على طريقة كيمياء الحُب من أول نظرة التي تشد الرباط بين عاشقين من أول وهلة كما عبّر عنها أمير شعراء العرب أحمد شوقي خير تعبير في بيته الشهير: نظرة، فابتسامة، فسلام، فكلام، فموعد، فلقاء، وكان ذلك في مهرجان للشبيبة التابعة للحزب الشيوعي الأسرائيلي عام 1965؛ حيث انجذب شاعرنا إلى جمالها الأنثوي الفتّان وبرقصها الجميل في وصلة أو فقرة رقص شعبية، واستمرت العلاقة بينهما حتى عشية نكسة 1967 العربية فانقطع حبل الوصال بين العاشقين على إثر تجنيدها في جيش العدو الأسرائيلي استعداداً لعدوانه الإجرامي المشؤوم في ذلك العام على العرب، وكانت هذه العلاقة حتى وهو في وطنه المحتل غير معروفة إلا للمقربين من أهله وخاصته من رفاقه في الحزب.
وفي فيلمها الوثائقي الذي أخرجته قبل بضع سنوات المخرجة ابتسام مراعنة تسلط الضوء على أبرز خفايا تلك العلاقة، بما في ذلك رسائل الشاعر التي كتبها بلغة عبرية شاعرية رقيقة شفافة ، حيث كان شاعرنا يجيدها باتقان إلى جانب اللغتين اللغتين الإنجليزية والفرنسية ، وناجاها بعدئذ في عدة مجموعات شعرية عربية: “آخر الليل” 1967، “ريتا أحبيني” 1969 في مجموعة العصافير تموت في الجليل، “أعراس” 1977، شتاء ريتا” 1992، فيما كان أول ديوان صدر له بعنوان “عصافير بلا أجنحة” عام 1960 وكان عمره وقتذاك 19 عاماً .
وفي مجموعة “ريتا أحبيني” لا يصرح بمكان الحبيبة ولا بهويتها، حيث كان مراقباً من العدو؛ هو الخارج من آخر معتقل من اعتقالاته المتكررة قبل سنتين ؛ بل يتخذ من اليونان مكاناً رمزياً لقصته حيث يخاطبها: “نامي هنا البوليس منتشر” فكأنه بذلك يتمثل كلمات شاعر العامية المصرية الوطني الشهير أحمد فؤاد نجم في حبه لمصر زمن السادات إثر تكرر مرات اعتقاله: “ممنوع من السفر .. ممنوع من الغنا .. ممنوع من الكلام .. ممنوع من الاشتياق .. ممنوع من الأستياء .. ممنوع من الابتسام .. وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات”.
والقصيدة تعكس مشاعر الشاعر الوطني الملتزم على المحك الصعب حينما يجد نفسه بين خيارين لا توفيق بينهما ولا ثالث لهما؛ فإما الحبيبة الوطن وإما الحبيبة المرأة ، فينحاز بلا تردد رغم مرارة الانحياز لصالح الحبيبة الأولى لا الثانية، ولعمري هذا ليُحسب موقف صمود نضالي لا يقل شجاعة وخطورةً عن صمود المناضلين في السجون أو تحت التعذيب، وذلك لما هو معروف عن سلاح المرأة الجبار بأنوثتها الطاغية لإصطياد المناضلين في شراك العدو؛ علماً بأن الشاعر – كما تردد – مرّ بتجربتين فاشلتين من الحُب فالزواج في المنفى؛ إحداهما مع السورية رنا قباني إبنة شقيق شاعر الغزل الشهير نزار قباني التي مما ورد في شهادة لها بعد مماته، حسب مجلة “سيدتي” الصادرة في 12 اغسطس 2015 ، إشادة ببعض مناقبه الإنسانية الثورية في الكرم والبساطة رغم فقره وزهده.
وكانت هذه الشهادة العلاقة – إن صحت كما رويت بتفاصيلها الدقيقة في أكثر من مصدر إعلامي- أشبه بشهادة الروائية السورية أيضاً غادة السمّان عن علاقتها بصديقه الروائي غسان كنفاني بعد رحيله إثر استشهاده الدموي الفاجع صيف 1972 والذي فتت العملية جسده متناثراً على سطوح بعض عمارات بيروت حال تشغيله محرك سيارته المفخخة على الأرض في واحدة من أبشع الجرائم الأسرائيلية، ولم تكن جريمته سوى أنه كان رئيس تحرير مجلة “الهدف” الناطقة بلسان الجبهة الشعبية التي تنشر بيانات عمليات الجبهة ضد جنود الاحتلال الاسرائيلي.
لكن في عشق محمود درويش الإنساني الذي لم يكن يرمي من نهايته سوى الوصول إلى قفص الزواج – وإن يكن ضمن قفص الاحتلال الأكبر – ظل مشدوداً حتى مماته إلى حُبه الأول مجسداً قول الشاعر أبي تمام: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحُب إلا للحبيب الأول.